يتعرض أكثر السائرين على طريق الذوق إلى المكاشفات والواردات. والكشف أو الوارد هو كل ما يرد على قلب الإنسان كنتيجة مباشرة للرياضة الروحية، ولتنقية النفس من شوائب الدنيا. والواردات من أخفى الابتلاءات في دلالاتها وآدابها، ولذلك فأهلها كثيرون، والمحسنون فيها قليلون. والكشف يكون على صنفين:
الأول: الكشف والواردات الكونية
هي كل ما يرد على قلب العبد مما يُفتَحُ له من أبواب عالم الشهادة. مثل رؤية أو سماع الجن أو آثار وجودهم، سواء كانوا صالحين أو طالحين، مثل قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾1. أو معرفة حدث حاصل في زمان ما ومكان ما، مثل رؤيا عزيز مصر لأحداث الجدب والجفاف2. أو معرفة بعض أحوال العباد مثل قصة العبد الصالح لما رافقه نبي الله موسى عليه السلام، وما علمه من أحوال أهل السفينة والغلام وأصحاب الجدار3. أو غير ذلك مما هو متعلق بالكون الذي نشهده وما فيه من مكونات سواء كانت محسوسة أو وراء نطاق الحس.
والواردات الكونية قد تكون عن الله، يلقيها في قلب العبد إما وحياً أو إلهاماً أو عن طريق ملك أو صالح الجن أو الإنس. وقد تكون من الشيطان فيخبر العبد بما يوقعه في فخ الشرك، أو مهارات وقدرات النفس المدربة روحياً. ومن ثم فالواردات الكونية تصيب كل أحد، المؤمن والكافر، والبر والفاجر. وكل من سلك طريق الرياضة الروحية مُقَدِّماً روحه على جسده ينال قدراً من هذه الكشوفات والواردات. لذا فهذا النوع من الكشف قد يطلبه الإنسان ويسعى لحصوله لجلب نفع أو دفع ضُرٍّ، سواء كان النفع أو الضرر شخصياً أو متعلقاً بمن حوله من الخلق. لذا لا يخلو طريق الواردات الكونية عند الكثيرين من شهوة صريحة أو خفية.
ومن آداب العبد في التعامل مع الواردات الكونية
ألا يرفع قدر نفسه، ولا يرى لها تميزاً عمن حوله من العبيد لورود هذه الكشوفات عليه. ويعينه على ذلك علمه بأن هذه الواردات يشترك فيها كل البشر على اختلاف معتقداتهم وأخلاقهم ومقاماتهم. وحصولها له لا يرفع له قدراً ولا يرقى به مقاماً.
ألا يدعي صفو ربانية هذه الواردات. إذ أنها ظنية المصدر، فقد تكون من الله أو من النفس أو من الجن أو من الشيطان. وقد يحدث التداخل فيبدأ الوارد رحمانياً ثم تتداخل عوامل النفس وهواجسها وإدراكاتها، أو الشيطان ووساوسه، أو الجن وما يبثون في سمع العبد وحسه.
أن يراعي أحكام الشريعة في التعامل مع ما ينتج عن هذه الواردات، مثل اجتناب سوء الظن والتجسس والغيبة والنميمة والحكم على الآخرين وإشعال الفتن والقول على الله بالظن وأمثال ذلك.
أن يتعامل معها بقلب يقظٍ مُوَحِّدٍ. فكثير من هذه الواردات – أو على الأقل دلالاتها – تأتي مطابقة لهواجس النفس ونوازعها. فقد يسقط في الشرك من حيث أراد التوحيد، ويقع في الخطأ من حيث قصد الصواب، وتغرر به الشياطين من حيث رمى إلى مصاحبة الملائكة.
الثاني: الكشف والواردات الإلهية
هي كل ما يرد على قلب العبد مما يفتح له من أبواب عالم الملكوت. وهو كل ما يقبع خارج أشياء هذا الكون. مثل رؤية الجنة والنار والملائكة والأموات من المرسلين والأنبياء والصالحين وغيرهم وما يشاء الله أن يطلع عبده عليه من الحكم والمعارف والعواقب والمآلات وغيرها من أمور الغيب. كما تشمل الشرائع الإلهية التي رضيها الله لعباده وأنزلها إليهم بإرسال رسله، والتي ختمت برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما من شرعة ولا منهاج يتنزل على قلب بشر بعده عليه الصلاة والسلام. وهذه الواردات الإلهية لا تكون إلا عن الله، يلقيها في قلب عبده بأي طريقة شاء ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾4.
وهذا النوع من الكشف لا يطلبه العبد. فمن طلبه وسعى إليه تفلت من بين يديه، ولم يزده تشوقه إليه إلا بعداً عنه. ومن لم يلتفت إليه وقصد بمجاهداته ورياضته الروحية مالك الملك، تشوقت إليه الواردات، وطلبه الكشف في اليقظة والمنام. وأساس ذلك أن الأصل ألا يطأ العبد في حياته عالم الملكوت ولا يدلف من بابه بجسده قط، ولا بشيء من متعلقات جسده. وإلا لاختلطت العوالم، ولضرب الجنون عقول العباد فلا يدرون أحياء هم أم أموات. ولما كانت تلك الأجساد الفانية ممنوعة من عالم الملكوت، فكل ما يتعلق بها من الشهوات الجسدية يسري عليه هذا المنع. ولذلك كان على العبد أن يفرغ قلبه من الشهوات ليكون قابلاً لتلقي الكشف الإلهي. والشهوة كل ما تميل له النفس لتحصيل لذة سواء كانت هذه اللذة مادية أو معنوية. فأما اللذة المادية فمعلومة مثل شهوة الطعام والنكاح والأموال وأمثالها. وأما الشهوة المعنوية فهو تخيل المعاني المجردة في صور حسية تحصل بها لذة النفس، مثل معنى القرب الإلهي وتخيله بصورة حسية مجسدة بحسب ما يرسمه العقل من صور متعلقة بالملائكة والعرش والأنوار وغيرها. أما إذا بقي ميل النفس إلى القرب الإلهي خالياً من الصور الحسية وعارياً من الخيالات فهو ميل وليس بشهوة.
فمن كان في نفسه شهوة صريحة أو خفية للواردات الإلهية لم يحصل عليها لانغلاق أبواب عالم الملكوت أمام الأجساد الفانية ومتعلقاتها من الشهوات. ومن أفنى شهوات نفسه انفتحت له أبواب الكشف الإلهي بإرادة الله. فمن تشتت قلبه وتفرق بين المصالح والشهوات والأماني والإرادات فمحال أن يغادر شواطئ الكشف الإلهي. أما من اجتمع قلبه وهمه وفكره على الله فيغوص في أعماق بحار الكشف الإلهي بأسرارها ومعانيها.
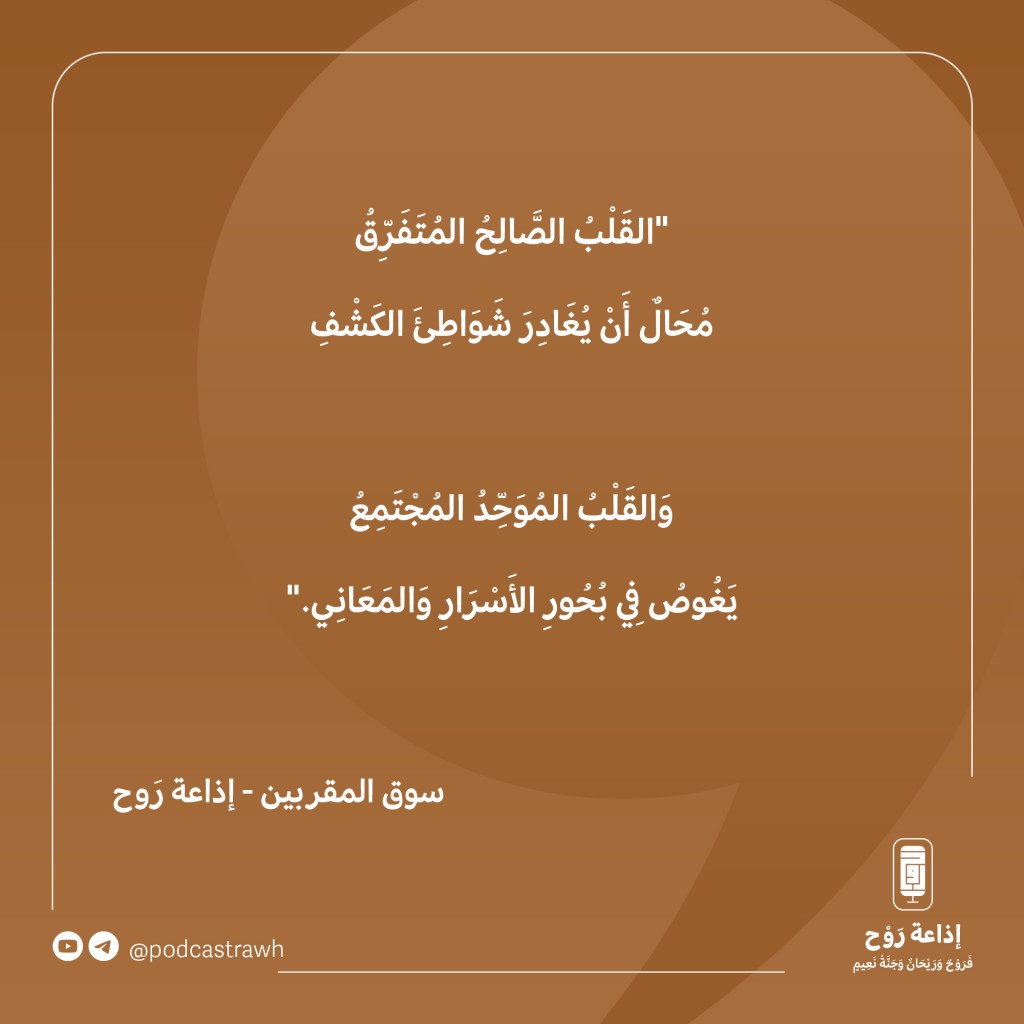
أنواع الكشف الإلهي
والواردات والمكاشفات الإلهية التي تقذف في قلب العبد لها أصناف ثلاث باعتبار سبب حدوثها: إما لتقوية اليقين، ليَجِدَّ السائر في سيره، ويبذل جهده في العروج بين المقامات والأحوال. فبقوة اليقين تتسارع الخطوات. فمن رأى الأنبياء ليس كمن سمع عنهم، ومن شم رائحة الجنة ليس كمن قرأ عن وصفها. فاليقين المشاهد يقوي العزم. أو تسرية للعبد ليصبر على بلاء المقام في دار الفناء وبلاء البعد عن دار القرار. أو ليسوق الله الخلق بحاجاتهم إلى ذلك العبد، ليكون باب هدايتهم وقضاء حوائجهم، فيصيبه فضل الله بالسبق وجزيل العطاء. فمن منحه الله تمام اليقين انقطع عنه النوع الأول من المكاشفات إذ لم يعد قلبه محتاجاً إليه. ومن اعتزل الخلق ورغب عنهم انقطع عنه النوع الثالث من الواردات. أما كشف التسرية فلا ينقطع عن العباد، إذ به تسكن القلوب فلا تتصدع من الغربة والشوق.
كما أن لها قسمين باعتبار حال المتلقي لها: الأول كشف قطعي الورود وظني الدلالة. فكل كشف أو وارد يرد على العبد فهو قطعي الورود، أي لا سبيل لنفي حدوثه. ولكنه ظني الدلالة، أي أن تفسيره ودلالته ليست قطعية، وذلك لتداخلات الطبع والهوى والإرادات والأماني والميل. وهذا حال أغلب السائرين على طريق الذوق. والثاني كشف قطعي الورود وقطعي الدلالة. وهذا يكون لمن فني عن نفسه، وأمات أهواءه وإراداته وأمانيه وشهواته، فما يرد على قلبه يكون قطعي الورود وقطعي الدلالة، وهذا حال عزيز، وقبس من ميراث النبوة. ومن خلط بين هذين النوعين فهو في ابتلاء عظيم.
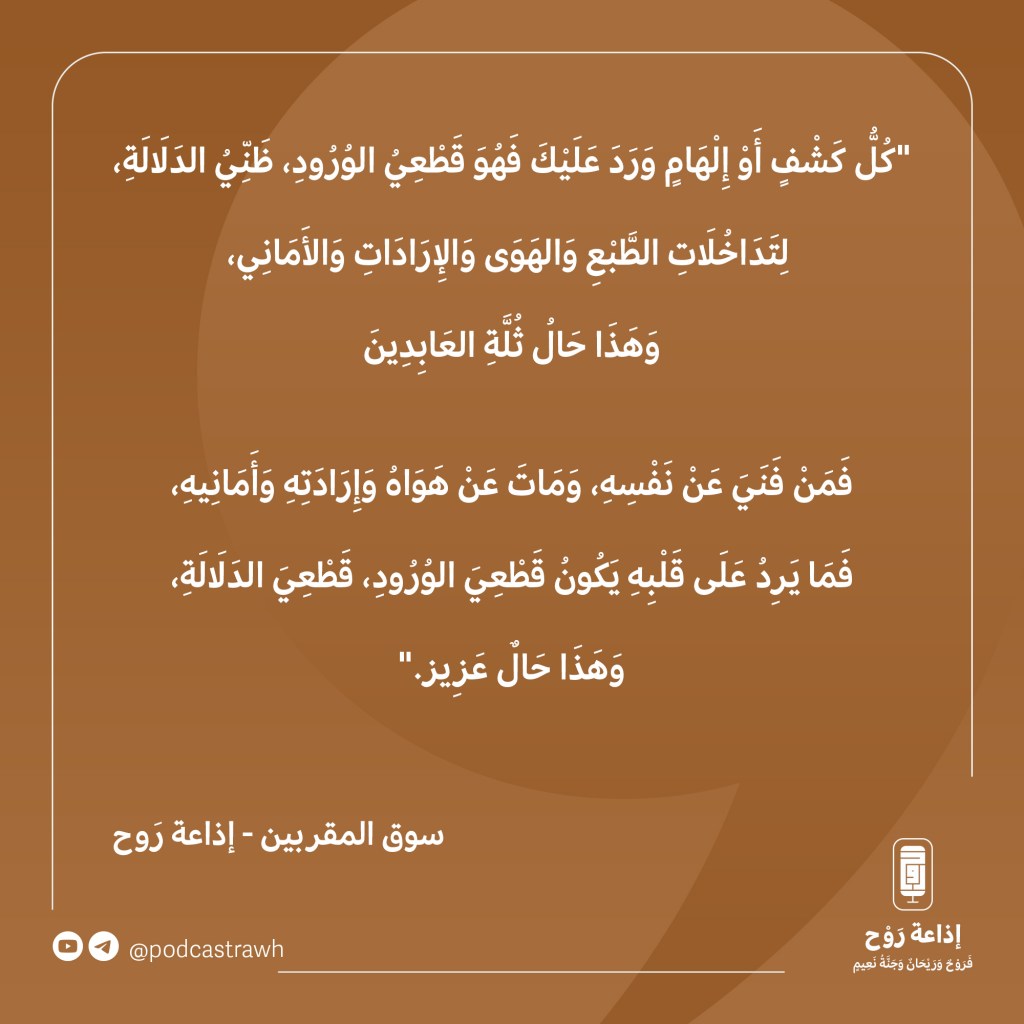
ومن آداب العبد في التعامل مع الواردات الإلهية
ألا يلزم أحداً بكشفه. فما دام الكشف لا يؤيده نص من القرآن أو السنة واضح صريح قطعي الثبوت والصحة والدلالة فليس له أن يلزم أحداً به. وإن جاء موافقاً لنص ففي النص الكفاية.
ألا يشرع تعبداً أو تسنناً بكشفه. فالتعبد والتسنن لا يكون إلا بنص. أما ما يرد في الكشف فهو استئناس أو إرشاد لحال مخصوصة وليس أحكاماً عاماً أو طرقاً للعبادة.
ألا يتعلق قلبه بها. وذلك بأن يعلم أن الكشف الإلهي طالب لا مطلوب. فمن اجتهد في طلبه أوقف على شاطئه، ولم يدرك قلبه إلى جميل منظره. أـما صاحب القلب المنصت إلى ربه فالكشف يطلبه، ويلقي به في أعماق بحره، فيغترف قلبه من كنوزه.
أن يتواضع بين يدي الواردات. وليعلم أنه إذا رأى من نفسه أنه في مقام الواردات قطعية الدلالة فإنه لا يزال دونها. فمن رأى نفسه فما فني عنها، وهذا مقام الفانين عن أنفسهم.
إن المكاشفات والواردات اختبار دقيق للقلوب، يتمايز به العباد في درجات توحيدهم لله. فكما أن من الاستدراج أن يوكل العبد إلى ما بين يديه من ظاهر النعم، فيسيء ويحسب أنه يحسن صنعاً. فيمتحن العبد بما يتحصل عليه من مال أو نفوذ أو مكانة أو قوة أو غيرها من النعم والأسباب الظاهرة. فإن من المكر أن يوكل العبد إلى ما في نفسه من باطن النعم والأسباب، فيرى لها فعلاً وقدرةً وعلماً وقدراً. فمن لم يتأدب بين يدي المكاشفات والواردات لم ينج من مكر الله، ومن راعى الآداب وألزم نفسه بمراعاة أصول “مركزية الله” و”الاستسلام لأسر شيء” و”إنما أنت عبد” نجا وأفلح وصفا توحيده.
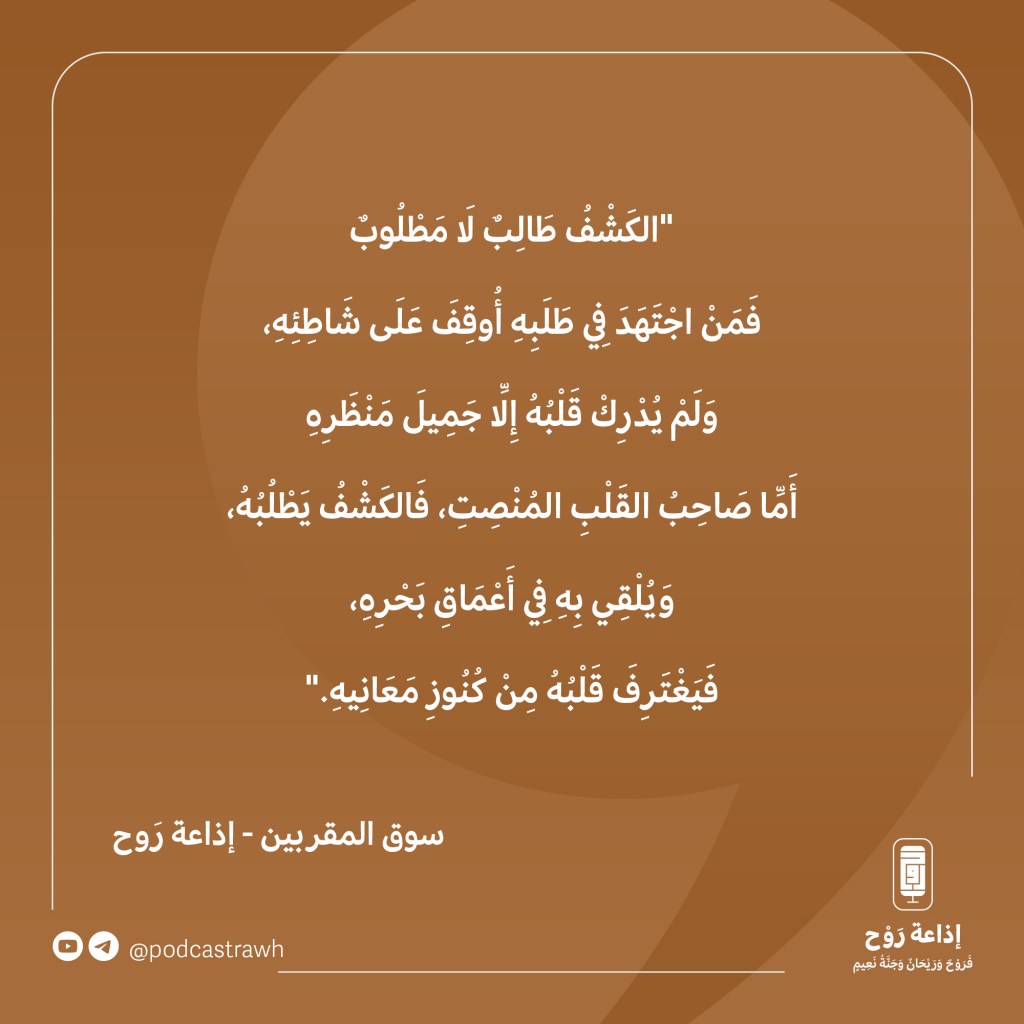
- سورة الأنعام. الآية 128 ↩︎
- يمكن مراجعة الرؤيا في سورة يوسف. الآيات 43 – 49 ↩︎
- يمكن مراجعة تفاصيل القصة في سورة الكهف. الآيات 71 – 82 ↩︎
- سورة الشورى. الآية 51 ↩︎
جميع مقالات “أصول الذوق”

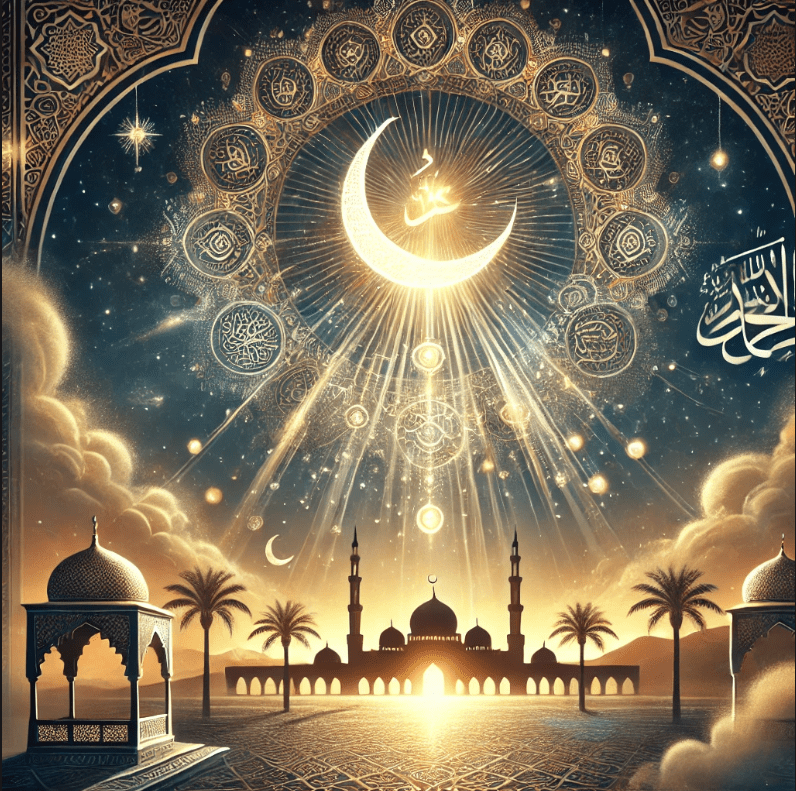
أضف تعليق