المقدمة
الحمد لله الذي لا إله إلا هو. ولا انتساب إلا له، فله وحده تنتسب جميع الخلائق، فالصفة المشتركة الجامعة لجميع موجودات عوالم الغيب والشهادة وما بينهما هي الخلق والعبودية. وإليه وحده تنسب القلوب قرباً أو بعداً، إقبالاً أو إعراضاً. والحمد لله الذي لم يشرك في ملكه أحداً، ولم يشهد أحداً خلق السماوات والأرض والأنفس، فكان أمرنا كله في قبضته وحده، ومصيرنا إليه وحده، وفقرنا وحاجتنا وذلنا إليه وحده. والحمد لله الذي جمع الطرق كلها فجعلها إليه، فما من سائر مقبل إلا إليه، وما من متوقف معرض إلا إليه، فالخلق كلهم سيرهم طوعاً أو كرهاً إليه، ويسبحون في أفلاكهم إلى مستقرهم إليه. والحمد لله لا فاعل إلا هو، ولا مدبر إلا هو، فما من سبب إلا والله هو المسبب له، وما من وسيط إلا والله هو الآمر له، فهو المتصرف وحده في جميع أمور الخلق يجريها كيف شاء، ومنه وحده تحصل النتائج والعواقب، فهو الملك المالك القادر العليم الحكيم الخبير. والحمد لله الذي تعرف إلى خلقه فدلهم عليه، وأراهم آثار أسمائه وصفاته ليعرفوه، فتعرف إليهم فعرفوه، وأحبهم فأحبوه، ورضي عنهم فرضوا عنه، وأحب لقاءهم فأحبوه لقاءه، وما زاد ذلك وما أنقص من ملكه ولا من عزته ولا من عظمته ولا من ألوهيته ولا من ربوبيته شيئاً، فالحمد لله على جمال وكمال ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، وما يزيد الحمد القلب إلا شوقاً، وما يزيد الشوق الروح إلا حزناً، وما يزيد الحزن النفس إلا زهداً، وما يزيد الزهد العبد إلا توحيداً.
شَــوْقٌ إِلَى المَحْبُــوبِ لَيْـسَ بِمُنْطَفِـــئ إِذْ لَا وِصَــالَ لِذَاتِــهِ مَـا مَــنْ حُضُورْ عَجْـــزٌ عَــنْ الإِدْرَاكِ يَأْكُــلُ مُهْجَتِـــي وَالعَجْــزُ عَــنْ إِدْرَاكِـهِ عِلْـــمٌ وَنُـــورْ "اللَّــــهُ يَــا اللَّـــــهُ" أَلْهَـــــجُ ذَاكِـــــراً إِنْ قُلْـتُ وَصْفـاً سَوْفَ أُرْمَى بالكُفُـورْ
وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية هو باب الطريق إليه، فمن لم يؤمن بالله إلهاً ورباً فما فتح له باب إليه، وما لاح في أفقه طريق موصل إليه، وإنما هو عبد يتخبط في سبل الاعتقاد متفرقاً همه وقلبه، فتمزق تجاذباتها نفسه ووجدانه. قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾1. فإذا شاء الله بفضله وبرحمته هداية عبد من عباده أشرقت أنوار الطريق أمام عينيه طوعاً أو كرهاً، ليجذبه بريقه واتساعه وجماله والطمأنينة والسكينة التي تغمر الطريق والسائرين عليه.
وتوحيد الله الواحد الأحد تكلم فيه وكتب عنه أهل العقائد والفقه والقرآن والحديث والكلام والذوق، فهو خزانة لا ينفد خيرها، ولا ينضب علمها، وكل يأخذ منها على قدر ما منحه الله من استعداد قلبه وعقله، بل كلٌ يكتب عن نفسه لا عن ربه، عن قابلية قلبه وعقله في إدراك الله وليس عن حقيقته سبحانه، تعالى ذو الجلال عن كل تصور وإدراك. ومن ثم فالكل يكتب ووجهه إلى نفسه لا إلى ربه، وما يخبر إلا ما تعكس مرآة قلبه وعقله من سبحات أنوار الله جل في علاه، والتي لو بدت على حقيقة ما هي عليه لصعق من في السماوات والأرض كلهم أجمعين، ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾2. وليس أحد بقادر على أن يخالف هذه الحقيقة، فما رسالة التوحيد هذه إلا رسالتي عن مرآة قلبي وعقلي، وعن ذوقي لوحدانية الله وأحديته، فهي إخبار عن أحوال العبيد لا عن حقيقة الله الذي ليس كمثله شيء، فما من شيء إلا وهو مخلوق، وتنزه المولى جل في علاه أن يشبه خلقه أو يحل بهم. فكل تصور عن ماهية التوحيد ذوقاً وشهوداً ما هو إلا كقطرة من بحاره، فما تعكس من حقيقته إلا عجزنا عن إدراكه.
ومنهج هذه الرسالة ذوقي، فهي تُصوِّر أذواق القلوب وشهودها لحقيقة التوحيد على قدر ما وصلت إليه القلوب من الذوق، وما قدرت عليه العقول من التصوير. والتعبير عن الذوق والمشاعر قد يخرج بالمتكلم عن حد الصواب، ويسقطه في هوة الشطح والأوهام، لذا قيدت قلمي بقيد الشريعة، فهو رقيق كالشعرة تحت نصل سيفها البتار. فما خرج عنها فلوهني وضعفي. ومن أراد أن يطير إلى التوحيد بجناحين متمكناً غير مضطرب، فليعقب هذه الرسالة بمزيد بحث في أصول التوحيد اصطلاحاً ولغة وعقيدةً، وليرجع إلى كتب العلماء الثقات ممن حازوا سبق العلم والقبول.
جناحا التوحيد
تبدأ معرفة العبد بتوحيد الله من فهم اسمين من أسمائه الحسنى، الواحد والأحد، فمنهما يبدأ الإحساس بالتوحيد وذوقه:
الواحدية
وردت بها اثنان وعشرون آية في كتاب الله، مثل ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ﴾3، و﴿وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾4. والمقصود بها تفرد الله سبحانه وتعالى بكونه رباً وإلهاً لكل شيء. فهو المتفرد عز وجل بالألوهية والربوبية لا يشاركه فيهما أحد. وما من ذات لها من الصفات ما يؤهلها لتقاسم ولو جزء يسير من الألوهية والربوبية معه سبحانه؛ بل ما من ذات موجودة على الحقيقة قائمة بنفسها إلا ذات الحي القيوم. فهو وحده الإله المعبود، وهو وحده المتفضل على كل ما سواه بالخلق والإيجاد، والعناية، واللطف، والرزق. وهذه الواحدية يعتقدها العبد بعد البحث في الدلائل المقروءة في النصوص المقدسة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المنقحة، وفي الدلائل المعقولة عقلاً ومنطقاً مثل التفكر في كيفية نشأة الخلق وحقيقة الموت وتعدد المخلوقات ووظائفها وأدوارها وأمثال ذلك من الدلائل العقلية.
والواحدية هي توحيد اللسان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والاعتقاد بأنه لا إله، ولا خالق، ولا رازق، ولا متصرف في الكون إلا الله وحده، ولا يشاركه أحد في مقام وأفعال الألوهية والربوبية. وهذا هو الحد الأدنى من الإيمان. بدونه لا يعد المرء مسلماً، ومن أنكره فقد أشرك بالله شركاً يخرج به من دائرة الإسلام. وهو توحيد عام، أو هو التوحيد العامي الظاهري، إذ ليس بالضرورة أن يكون المسلم قد أحسن التعرف على ربه بأسمائه، أو شهد قلبه تجلى صفات الله الفعال لما يريد لتقبل شهادته بالتوحيد واقتناعه بوحدانية الإله والرب.
الأحدية
وردت مرة واحدة بصيغة مباشرة في كتاب الله في سورة الإخلاص، في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾5. والمقصود بها تجلي أسماء الله سبحانه وتعالى في كل شيء خلقه وقدره. فيرى العبد آثار أسماء الله وصفاته في كل شيء حوله. ويرى ختم التوحيد في كل المخلوقات سواء كانت حية أو جامدة، متحركة أو ساكنة، مرئية أو محسوسة. وهذه الأحدية يدركها العبد ذوقاً ووجداناً، ولا سبيل للتحليل العقلي أو البحث المنطقي إلى إدراكها أو تحصيلها.
والأحدية هي توحيد القلب، وهو توحيد لا سقف ولا حدود له، إذ بقدر تعرفك على الله تبارك وتعالى يزداد توحيد قلبك، وبقدر جهلك يزداد شرك القلب. وشرك القلب في هذا السياق لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، ولكن بقدر تحقق القلب بالتوحيد وانحسار الشرك فيه يرتفع المؤمن في مقامات وأنوار الإيمان والقرب، ومن هنا تختلف درجات أهل الجنة. فهناك أهل اليمين والمقربين والمنعم عليهم من الأنبياء، والصديقين، والشهداء، والصالحين.
واختلاف الخلق في سعيهم وأعمالهم ما بين سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه إنما يكون لتفاوتهم في مقدار التوحيد في قلوبهم. فكل صفة سنية في العبد أصلها توحيد، وكل صفة له دنية أصلها شرك. فالعبد القلق لم يتحقق في قلبه إفراد الله بالتدبير، فيشارك ربه – وهماً وظناً – في تدبير أمره فيصيبه القلق والحيرة لقلة حيلته وضعفه. والعبد الحاسد لم يتحقق في قلبه إفراد الله بالقسمة، فتظن نفسه أنه أجدر وأولى من غيره برحمة الله المنزلة على خلقه والتي يقسمها بينهم كيف شاء.
وهكذا في جميع الصفات والأحوال، فإن أصلها توحيد الله تبارك وتعالى في كل اسم من أسمائه وصفة من صفاته العلية. فكما يتحقق القلب بكمال توحيد صفة الخالق بالإيمان الجازم والمطلق أنه لا خالق إلا الله، فهو يسعى أيضاً لكمال توحيد صفتي الكبير المتعالي.
فمثل الواحدية كمثل الشخص المحب للفنون، إذا زار مرسماً أعجبته الرسوم وبديع ألوانها وجميل أشكالها وما تعبر عنه، وربما اقتنى منها ما تمتعت به عينه، وذهبت إليه نفسه. ومثل الأحدية كمثل الحاذق الخبير في عالم اللوحات الفنية، إذا ما زار مرسماً أدرك أنواع الخطوط المختلفة، وصفات فرش التلوين المستخدمة لإبراز كل تفصيلة في اللوحة، وأنواع الألوان، وتوقيع الرسام، بل ربما عرف اسم الرسام من انحناءات الخطوط وطرق التلوين وغيرها. فالواحدية يدركها كل أحد، والأحدية معنىً عميقاً، وذوقاً رفيعاً لا يدركه إلا أصحاب المجاهدات الذوقية، فكأنهم يرون ختم التوحيد في كل ما سوى الله6.
تحقق القلب بالتوحيد
الفارق بين تحقق العقل والقلب بالتوحيد
تحقق العقل بالتوحيد يختلف عن تحقق القلب به. فتحقق العقل بالتوحيد يعني الإقرار المعرفي والعقلي سواءً بالأدلة العقلية والنقلية بأن الله واحد لا شريك له في ملكه، ولا خالق سواه. وهي رحلة عقلية بالأساس، ولكنها متعلقة بقبول القلب وليونته وانقياده للحق متى تبين. أما القلب المعاند المكابر فما تزيده الأدلة والآيات إلا مرضاً فوق مرضه، وإعراضاً فوق إعراضه. إذ أن لقرارات العقل في أي رحلة يندفع فيها الإنسان – وتكون وجهتها معاني الروح والحياة والإله وأمثال تلك المفاهيم – أثر على القلب والنفس، وأحكام على الجسد والعلاقات. فمتى قبل القلب انقاد، ومتى رفض قاوم وتمرد وتكبر.
وأما تحقق القلب بالتوحيد فهو إدراك القلب ورؤيته وشعوره وتذوقه بأن كل ما حوله ومن حوله عبيد مخاليق مشدود أسرهم، لا يملكون من أمرهم شيئاً، وأن لهم خالقاً قاهراً فوقهم، تفضل عليهم بالإيجاد والخلق. وهي رحلة قلبية ذوقية في الأساس، يتفجر القلب فيها حباً وشوقاً، وسكوناً واضطراباً، ويقيناً وحيرة، وفرحاً وحزناً، ويتجاذبه وجوده وعدمه.
عوائق تحقق القلوب بالتوحيد
هناك كثير من الأسباب التي تلفت القلب عن التحقق بالتوحيد، وسنتناولها تفصيلاً في رسالة الصوارف مع غيرها من العراقيل التي تصرف العبد عن الطريق إلى الله عز وجل. إلا انني في سياق الحديث عن التحقق القلبي بالتوحيد سأتعرض لعقبات ثلاث كبرى
أولاً: حالة الكثرة
هذه الأحوال والمشاعر المتناقضة في طريق القلب إلى ذوق معنى التوحيد مردها تلك الكثرة التي تحيط بنا. فالله الخالق البارئ المصور لم يزل خالقاً مصوراً، وتفيض الأكوان بقدرته على الخلق والإيجاد. وكل المخلوقات في عالم الشهادة متداخلة ومتفاعلة، يقود بعضها إلى بعض، وهو ما أشار إليه علماء الفلسفة والفيزياء، فيقول الفيلسوف الألماني يوهان فيتشه: “لا يمكنك إزالة حبة رمل واحدة من مكانها دون تغيير شيء ما عبر جميع أجزاء الكل اللامحدود”7. وإلى مثل هذا المعنى أشارت نظريات مثل نظرية الفوضى وتأثير الفراشة، وتأثير كرة الثلج، والتفاعل التسلسلي، وتأثير الدومينو، ومثال ذلك من النظريات التي تؤكد على الترابط والتفاعل بين تلك الكثرة من المخلوقات بدءاً من أصغر ذرة وحتى أكبر مجرة. ومن ثم فأي فعل في عالمنا له عاقبة ونتيجة ورد فعل، ولا يمكن تصور شيء بخلاف ذلك. ولكن حقيقة التوحيد هي النقيض لهذه الكثرة. إذ لا وجود على الحقيقة إلا لله الواحد، وكل وجود سواه هو وجود انتساب له، أي ينسب إلى الله علماً وإرادة وقدرةً وفعلاً وخلقاً وإيجاداً، فكل هذه الكثرة دليل على واحد لا موجد له، وليس معه شيء، وليس كمثله شيء، تمايز عن خلقه فلا يحل بهم وليسوا هم ذاته العلية، ولا ذاته تبارك وتعالى ذاتهم، وفعله وحكمه في خلقه لا أثر ولا عاقبة لهما عليه لا نفعاً ولا ضراً، إن شاء أوجدها وإن شاء أهلكها، وفي الحالين لا يترتب على ذلك نفع ولا ضر عليه، ولا ينتابه ندم ولا أسى، ولا زيادة علم أو ملك ولا نقصانهما، ولا يطرأ عليه تبدل ولا تغير ولا زوال ولا ذل ولا حاجةـ تبارك وتعالى سبحانه عن كل كمال وتنزيه تتصوره عقولنا. فهو الواحد الغني بذاته، فلا يحتاج إلى شيء لوجود ذاته، أو أسمائه، أو صفاته، أو أفعاله. وإذا كانت حقيقة التوحيد هذه متصورة إيماناً وتسليماً، فإن ذوقها وشهودها وعدم رؤية ما سواها رحلة من نوع آخر، وهي رحلة تحقق القلب بالتوحيد، وبها يتمايز المقربون والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء، فتتفاوت منازلهم، ودرجات قربهم من الله الودود الغفار.
ولا يحيط أحد من الخلق يتوحيد الله إلا الله ﷻ، فهو كان ولا يزال واحداً أحداً، وكمال التوحيد والإحاطة بمعناه العقلي والذوقي القلبي يتطلب كمال معرفة الله وإحاطة العلم به جل في علاه إحاطة عقلية وقلبية ذوقية، وهذا محال. فلا يعرف الله حق المعرفة إلا الله، ولا يدرك أحدية الله وواحديته حق الإدراك إلا الله. أما الخلق الذين يقوم عالمهم على الكثرة والتعدد ووجود الأغيار، فلا يتصورون عقلاً ولا شعوراً تلك الحالة من الواحدية الأحدية. فلا يخلو توحيدهم من نقص، ولا يخلو تنزيههم للواحد الأحد من علة، كونهم يوحدون وينزهون بحسب ما وصلت إليه عقولهم وقلوبهم من كمالات مقيدة بهذا العالم الذي يحيط بهم، ولذلك لا يتوقف قلب المؤمن عن الاستغفار، وسؤال الله الرحيم الغفار أن يمن عليه بما يرضاه جل وعلا منه من توحيد، وأن يقبل منه توحيده على نقصه وعلته، وأن يعفو عنه لضعفه وقصوره عقلاً وقلباً. ومن ثم يختلف العباد في درجات توحيدهم لله، وإدراكهم وشعورهم وذوقهم لواحدية الله وأحديته.
ثانياً: قابلية القلوب للتوحيد
فضل الله بحكمته وإرادته بعض العباد على بعض، وفضل بعض النبيين والرسل على بعض. وحقيقة هذا التفضيل هو حد كمال التوحيد الذي استودعه الله في قلب عبده. فإذا افترضنا كمالاً مطلقاً يتنزل على قلوب العباد، فلكل قلب سعة استقبال لا يمكنه تجاوزها. فالقلوب تتفاوت في سعة وعاء الكمال لديها، فمن امتلأ خزان الكمال لديه فلا يستطيع أن يزيد عليه مثقال حبة من خردل. ولا يزال إدراك العبد واستيعاب قلبه للتوحيد في ازدياد حتى يمتلأ وعاء القلب. وأوسع القلوب استعداداً وقابلية لتلقي كمال التوحيد هو قلب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم تتفاوت قابلية قلوب الرسل والأنبياء بحسب ما فضلهم الله تعالى، ثم قلوب الأولياء والصديقين والصالحين والشهداء بحسب مقاماتهم عند الله تبارك وتعالى. فنصيب القلوب من التوحيد ليس واحداً، فبلوغ قلب العبد الصالح منتهى كمالاته غير بلوغ قلب النبي والمرسل منتهى كمالاته. فمنتهى كمالات القلوب متباينة، والفائز السعيد من بلغ كمال قابلية قلبه واستعداده لقبول التوحيد، والناجي من امتلاً قلبه بأي قدر من التوحيد، أما الخاسر فهو من فرغ وعاء قلبه من التوحيد. والحمد لله الذي قبل من عباده توحيده لهم على قدر استعداد قلوبهم وعقولهم، فلم يكلفنا إلا وسعنا.
ثالثاً: “التوحيد” مصطلح ثقيل
عند الحديث عن التوحيد نكون أمام أحد اثنين. أولهما ذلك العبد المؤمن العالم أو طالب العلم، الذي قد تحقق عقله بالتوحيد. فأقر معرفيا وعقلياً بالأدلة المنطقية والنقلية بأن الله واحد لا شريك له في ملكه، ولا خالق سواه. وقبل قلبه هذه الحقيقة وانقاد لها. بل وزاد على ذلك بدراسة ما قيل في التوحيد مما ذكره علماء العقائد والفقه، وقد يكون له إطلاع على أقوال الفرق واختلافها في مباحث التوحيد. وقد يكون هذا العبد ممن من الله عليهم بإتيان المأمورات، واجتناب المنهيات، والتعرض لمواسم وأوقات النفحات. فإن دعي لتوحيد القلب ربما استنكر هذه الدعوة واستغربها، ووقف حاله هذا حاجزاً بينه وبين الاستماع. فتحدثه نفسه مستنكرة: وهل مثلك يجهل التوحيد.
وثانيهما العبد المؤمن غير المتخصص في علوم الشريعة. فيجد نفسه أمام مصطلح محمل بالسجالات الفلسفية والعقائدية في التراث الفكري الإسلامي، وهو من العلوم الثقيلة عقائدياً وفلسفياً والتي لا يمكن لأي أحد هضمها والتمكن منها. فمجرد ذكر مصطلح “التوحيد” يوحي للنفس بأنها أمام قضية مستعصية زاخرة بالخلافات والآراء. وهي ليست اختلافات في الفروع والأحكام؛ وإنما في الأصول المتعلقة بطبيعة الإله المعبود وصفاته وأفعاله. فالخلاف في الفروع يُخرج من المذهب، وفي الأصول يُخرج من الملة. وهو ما تنفر منه النفوس. ثم إن الحديث عن “التوحيد” يرافقه ذكر “الشرك”، فتجفل النفس نافرة من نعتها بذلك الوصف.
درجات التوحيد
أولاً: توحيد الإسلام
هو التلفظ القولي بـ “لا إله إلا الله”، مع التصديق بأنه لا إله ولا رب إلا الله تبارك وتعالى. وهو أول درجات التوحيد والإسلام. وكما قال المولى ﷻ: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾8. ولا يعني ذلك أن قلب العبد في هذه الدرجة لا تغشاه السكينة والخشوع ومظاهر الإيمان عند التعرض لنفحات الله تبارك وتعالى في أوقات ومواسم الخير اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية؛ وإنما الحديث هنا عن حقيقة إدراك واحدية الله وأحديته.
ثانياً: توحيد الإيمان
وهو إفراغ القلب من كل صفة تشرك بها نفسك أو أحدأً من خلقه معه سبحانه وتعالى. وهو مرتبة ودرجة أعلى في التوحيد، وهو أول مراحل الرحلة القلبية في الطريق إلى الله جل وعلا، وتنفق فيه أعمار ومجاهدات، إذ أي تغير يراد بالقلب لا يحدث جملة واحدة، وإنما يجاهد العبد نفسه، ويكابد ويجد في اصطياد أمراض قلبه ومعالجتها ومداواتها برحمة الله وفضله. ومن ثم فإن تمكن العبد من توحيد الإيمان هو ثمرة الارتقاء في معارج الإيمان القلبي، ومعاينة القلب للأحوال والمقامات المختلفة حتى يفرغ من كل شرك متصور بالله سبحانه وتعالى.
ثالثاً: توحيد الإحسان
ملء القلب بصفات الجلال والكمال، فتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو الذي أشار إليه الإمام الهروي بتوحيد الخاصة: “وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، والصعود عن منازعات العقول، وعن التعلق بالشواهد. وهو ألا تشهد في التوحيد دليلاً، ولا في التوكل سبباً، ولا للنجاة وسيلة، فتكون مشاهداً سبق الحق بحكمه وعلمه، ووضعه الأشياء مواضعها، وتعليقه إياها بأحايينها، وإخفائه إياها في رسومها، وتحقق معرفة العلل، وتسلك سبيل إسقاط الحدث”9.
فتوحيد الإحسان هو شهود الله عز وجل وحده دون سواه. فلا ترى أسباباً ولا وسائط ولا فاعلاً سواه، ولا تشهد حواسك إلا آثار أسماء الله عز وجل وفعل صفاته في نفسك وفي كل ما حولك من جمادات وأحياء وأحداث وعواقب.
وحتى يصل العبد إلى كمال توحيد الإحسان، يشهد أختاماً ستةً في الكون، وليس شرطاً ان تأتيه على هذا الترتيب، وإنما يتحصل عليها بحسب مجاهداته وأذكاره وأحواله القلبية:
أولها: أن تشهد “ختم الخلق” في كل ما في الكون. وأقصد بـ “ختم الخلق” أن يرى قلبك كل ما حولك من جمادات وحيوانات ونباتات وما فوق ذلك وما أصغر مخلوقات، خلقها الملك الحكيم العليم. فما ثم حولك إلا مخلوق مصنوع أوجده الله وصوره على تلك الهيئة التي تراها. فليس في الكون إلا مخاليق، وما تقع حواسك إلا على مخلوق. فيرى قلبك كل ما حولك مختوماً بـ “ختم الخلق”.
ثانيها: أن تشهد “ختم العبودية” في كل ما في الكون. وأقصد بـ “ختم العبودية” أن يرى قلبك كل ما حولك من جمادات وحيوانات ونباتات وما فوق ذلك وما أصغر عابدين خاضعين ساجدين لله تبارك وتعالى، يسبحون بحمده كل بما أوحى إليه ربه. ألم يقل ربنا ﷻ: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾10، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾11، وقال: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾12، وأخبر قائلاً: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾13، وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾14. فما ثم حولك إلا عبد لله، خاضع لشروط العبودية، مشدود أسره، لا فكاك ولا مهرب له منها، وكل ما حولك من جمادات وحيوانات ونباتات وما فوق ذلك وما أصغر ساجد لله العزيز الحكيم، ومسبح بحمده، شاء ذلك أم أبى. فيرى قلبك كل ما حولك مختوماً بـ “ختم العبودية”.
ثالثها: أن تشهد “ختم الإدراك”. وأقصد به أن يشهد قلبك إدراك كل ما في الكون جامداً كان أو حياً، صغيراً أو كبيراً، لله عز وجل ومعرفتهم به. فالله أخبرنا أنه ما كلف أحداً من خلقه سوى الإنس والجن، والتكليف والحساب يقتضي الحجاب ليحصل الاختبار، ويكون الخضوع لله إيماناً وتسليماً لا كرهاً وإجباراً، وهو ما جاء به القرآن الكريم في قوله ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾15. فكل ما سوى الإنس والجن لا حجاب من الدنيا مضروب عليها، فإدراكها وعلمها بالله تبارك وتعالى يتجاوز إدراكنا وعلمنا. فهذه الجبال والأحجار تتصدع خشوعاً وخشيةً لله الواحد القهار، وتلك السماوات والأرض تكاد أن يتفطرن من ادعاء أن للرحمن ولداً، وما تبكيان ولا تحزنان لموت المتكبرين المعاندين لما أنزل الله، وأدركت المخلوقات حقيقة أمانة التكليف فأبين وأشفقن منها وحملها الإنسان بجهله، وخطاب هدهد سليمان ووصفه لأسماء الله على أحسن وجه، وإدراك النملة نبوة سليمان وعدله، وتسبيح الرعد بحمد الله الكبير المتعال. فكل ما يحيط بك عارف بالله، وعالم بالله، ومدرك حقيقة التكليف والأمانة، ويفرق بين المؤمن بالله والمؤمن بما سواه. إدراك عاقل كامل حجب الله عن بني آدم فقهه ورؤيته لتكتمل أركان امتحان الإيمان، وأزال بعضاً من هذا الستر والحجاب عن بعض خلقه ممن اصطفاهم واجتباهم ليريهم ملكوت السماوات والأرض وليكونوا من الموقنين، فيروا كل ما في الكون مختوماً بـ “ختم الإدراك”.
رابعها: أن تشهد “ختم عدمك”. أي تخرج من صحراء وجودك إلى بستان عدمك. أي من شهود نفسك وفعلها ووصفها إلى شهود آيات الله وفعله وأسمائه في كل شيء، فلا ترى شيئاً إلا عن الله صادراً، وإلى الله صائراً، ومن الله مقدراً. فما ثم حركة ولا سكون، ولا صوت ولا سكوت، ولا قيام ولا قعود، ولا فعل ولا توقف، ولا بقاء ولا فناء، ولا حياة ولا موت إلا عن الله الفعال لما يريد. فكل موجود وفعل حولك علمه الله العليم الخبير في قديم علمه، وأوجده بإرادته، وأنفذه بقدرته. فإذا شهد قلبك علمه وإرادته وقدرته في كل ما أحاطك ذهلت عن نفسك، فلم تعد ترى لها فعلاً ولا تركاً ولا أثراً، فلترى بالله، وتسمع بالله، وتنطق بالله، وتسكن بالله، وتتحرك بالله، وتفعل بالله، وتترك بالله، ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾16.
فإذا تم لك ذلك أدرك قلبك أنه لا وجود على الحقيقة إلا لله الحي القيوم، فهو الموجود مطلقاً بلا مقدمة تقود إليه ولا سبب يؤدي إليه، لا لتحقيق وظيفة مرجوة، ولا دور مقصود، بل هو موجود بذاته. أما نحن فوجودنا وجود انتساب، فنحن موجودون بالله، أوجدنا وخلقنا لحكمة في قديم علمه، ولتكليف مأمورون به، أخرجنا من العدم إلى الوجود بلا اختيار منا، يحيينا ويميتنا ويبعثنا كيف شاء ومتى شاء، مشدود أسرنا، لا فكاك لنا ولا مهرب من حكمه، فهو وجود بالله لا بذواتنا، وهو وجود انتساب له عز وجل لا وجود مطلق.
فمن كملت له هذه المشاهدة خرج من جدب صحراء نفسه إلى سعة وفيض وغني الغني الحميد. وقلب القائم بنفسه المشاهد لها ضيق، تحيط به أفعاله وقدراته وظنونه وأفكاره فتحبسه في داخله، أما القلب المشاهد لأسماء الله وأفعاله وصفاته فهو يسبح في فعل الله الذي لا نهاية له، ولا شقاء فيه، فيتقلب في خير فوقه خير، وفي نور عليه نور، فيتسع القلب للخلق جميعاً، إنسهم وجنهم، برهم وفاجرهم، حيوانهم وجمادهم، كبيرهم وصغيرهم، ويتفاعل معهم لتحقيق مراد الله فيهم، فسلمه عن سعة، وحربه عن سعة، وحبه عن سعة، وبغضه عن سعة، ورحمته عن سعة، وشدته عن سعة، فلا يغضب ولا ينتقم ولا يحب ولا يسالم لنفسه. فمن شهد “ختم عدمه” تجلى له الله تبارك وتعالى باسمه الواسع، فيتسع قلبه بحسب ما وضع الله فيه من قبول الوسع، فيكون رحمة لمن حوله.
خامسها: أن تشهد “ختم الخيرية” في كل ما حولك. وأقصد به أن يشهد قلبك أن كل ما في الكون هو في حقيقته في قبضة الله، وعند الله. وما عند الله خير، وبيده سبحانه الخير، وكتب عز وجل على نفسه الرحمة، فليس في الكون على الحقيقة إلا خير، وإنما اختلفت طرائق إيصاله إلى العباد بحسب ما يقتضيه الحال، فما الشقاء والبلاء إلا خطاب من الله إليك، ظاهره فيه الضر، وباطنه نور وخير ورحمة. وانظر إن شئت في قصص القرآن الكريم عن الأنبياء والمرسلين والصالحين، ما من بلاء إلا وكان فيه من الخير ما يفيض عليهم وعلى أممهم، وهذا نبي الله ووليه يوسف عليه صلاة الله وسلامه، عاين الغدر والبغض وفقد الأهل والعبودية وفتنة النساء والسجن من طفولته إلى كهولته، ولم ير قلبه إلا ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي﴾17. فما رأى قلبه شقاءً قط، وإنما خير وإحسان ورحمة. ومن عاين ما تمر به الأمم والأفراد من شقاء وجد أن العاقبة تكون دائماً خير، فربما هلكت أمة لتنهض أخرى، أو ظُلِمَ صالح لينتشر ويسري صلاحه في الناس، أو تجبر فاسد ليعاف الناس الظلم والفساد. ومن ثم فما من شقاء موجود على الحقيقة؛ وإنما هو الخير، وإن شئت فقل، الخير وجوده حقيقة والشقاء وجوده وجود انتساب إلى هذا الخير. وباختلاف حال المخاطب ومراد الله من العبد تأتي الرسالة الإلهية، فقد يأتي الخير ظاهره نعمة أو شقاء، وإنما يطول البلاء والضر إما لعجزنا عن الوصول إلى ما في لبه من الخير، أو لحكمة يريدها الله بالعبد سواء أدركها أو لم يدركها.
سادسها: أن تشهد “ختم الواحدية”. أي أن تشهد أثر الخالق في كل صنعة. فالله الخالق البارئ المصور لم يزل يزيد في الخلق ما يشاء، ومن فيض غنى الرحمن وقدرته على الخلق والفعل لا يتكرر تجلٍ لأسمائه مرتين، فهو الغني عن التكرار والتقليد سبحانه تنزه عن كل نقص. فما من خلق صغر أو كبر إلا وهو متفرد بما منحه الله من التمايز عن غيره، فلا تتكرر نفس ولا حدث ولا نبي ولا ولي ولا ذرة ولا مجرة. فمن أثار اسم الله الواحد اتصاف كل ما خلق الله بالواحدية، أي أن كل نفس واحدة في ذاتها لا تكرار لها، وكل حدث واحد في ذاته لا تكرار له، وهكذا في جميع ما خلق الله. وما نراه من تكرار إنما هي أنماط إحصائية ملحوظة منشؤها التقارب والتشابه وليس التماثل. فما من قطرة ينظر العبد إليها، أو ورقة نبات يداعبها النسيم، أو حبة رمل تسافر على جنبات الطريق إلا ولله أثر فيها واضح. وإنما نحجب عنه بانشغالنا وغفلتنا.
فمن أتم الله له هذه الأختام الستة، فأصبحت حواسه تشهد كل ما حولها عبيداً مخاليق، وشهد حقيقة إدراك غير المكلفين من الجمادات والأحياء بربهم، فقد فارق وجوده إلى عدمه، ورأى أثر الخالق في كل شيء، فقد كمل له توحيد الإحسان بحسب ما وضعه الله فيه من استعداد قلبه لبلوغ كماله.
رابعاً: توحيد المقربين
إذ يفيض الرحمن على قلوب من يشاء من خلقه بمعانٍ للتوحيد تعجز عنها الكلمات والعبارات. وهو الذي أطلق عليه الإمام الهروي توحيد خاصة الخاصة، وقال عنه أنه “توحيد اختصه الحق لنفسه، واستحقه بقدره، وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته، وأخرسهم عن نعته، وأعجزهم عن بثه.. فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء، والصفة نفوراً، والبسط صعوبة، وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال، وله قصد أهل التعظيم، وإياه عني المتكلمون في عين الجمع، وعليه تصطلم الإشارات، ثم لم ينطق عنه لسان، ولم تشر إليه عبارة..”18.
ولا يعرف التوحيد حقاً إلا الله ﷻ، فهو كان ولا يزال واحداً أحداً. أما الخلق فيقوم عالمهم على الكثرة والتعدد ووجود الأغيار، فلا يتصورون عقلاً ولا شعوراً تلك الحالة من الواحدية الأحدية. فلا يخلو توحيدهم من نقص. ولذلك لا يتوقف قلب المؤمن عن الاستغفار وسؤال الله ﷻ أن يمن عليه بما يرضاه ﷻ منه من توحيد.
- سورة الأعراف. الآية 143 ↩︎
- سورة الأنعام. الآية 153 ↩︎
- سورة البقرة. الآية 163 ↩︎
- سورة التوبة. الآية 31 ↩︎
- سورة الإخلاص. آية 1 ↩︎
- لا يوجد اتفاق بين العلماء عن معنى الواحدية والأحدية من جهة التحقق بالتوحيد. وقد يكون ذلك لدقة الكلمتين لغة واقترابهما في المعنى واشتمال إحداها على الأخرى. فذهب المتصوفة من أهل السنة إلى التفريق بين المقامين ثم لم يلتزموا بالتفريق بينهما عند الحديث عن التحقق بالتوحيد، بينما لم يفرق متصوفة الشيعة بينهما عند التحقق بالتوحيد، إذ لا فرق عندهم بين مقام الواحد والأحد في مقام التوحيد. لذا فرقت بينهما بحسب ما فهم العقل وخبر الذوق من كلا المعنيين. فانطلاقاً من المعنى اللغوي، الواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى. لذا الواحدية متعلقة بالإقرار والأحدية متعلقة بشهود المعنى. وليس الاتفاق مطلوباً لذاته؛ وإنما هي دندنات حول التوحيد وذوقه، وكل له دندنته. ↩︎
- ‘Die Bestimmung des Menschen’ is quoted with the page numbers of the original edition of 1800: https://archive.org/stream/bub_gb_vF8AAAAAMAAJ#page/n11/mode/2up , accessed on 02 June 2024 ↩︎
- سورة الحجرات. الآية 14 ↩︎
- عبد الله الأنصاري الهروي. منازل السائرين. دار الكتب العلمية. بيروت – لبنان. 1988. ص136. ↩︎
- سورة الرعد. الآية 15 ↩︎
- سورة النحل. الآية 48 ↩︎
- سورة النحل. الآية 49 ↩︎
- سورة الإسراء. الآية 44 ↩︎
- سورة النور. الآية 41 ↩︎
- سورة الشعراء. الآية 4 ↩︎
- سورة الأنعام. الآية 162 ↩︎
- سورة يوسف. الآية 100 ↩︎
- عبد الله الأنصاري الهروي. منازل السائرين. دار الكتب العلمية. بيروت – لبنان. 1988. ص136. ↩︎
مجموعة رسائل المقربين

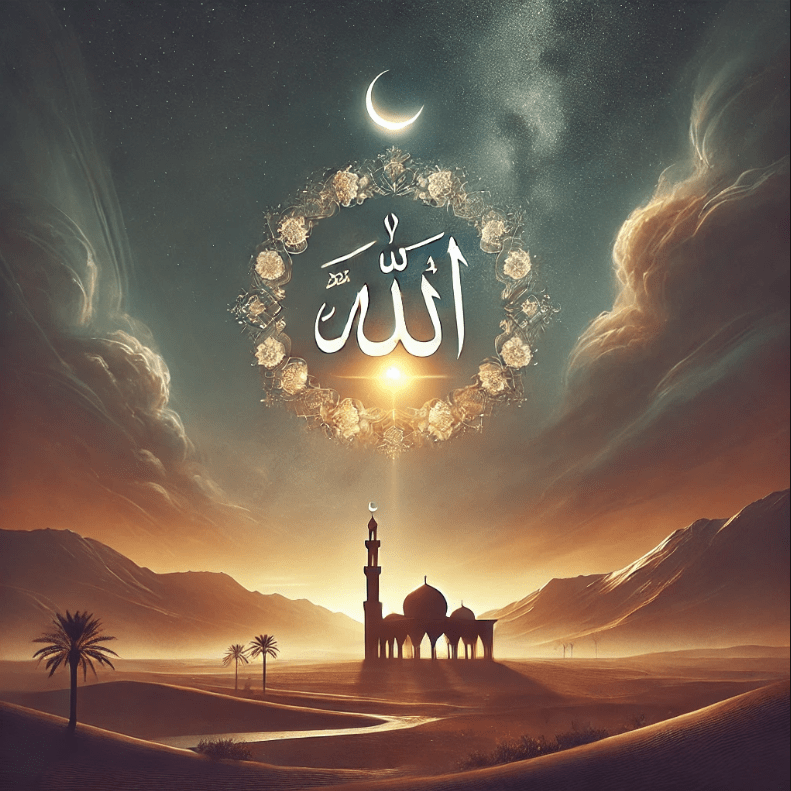
أضف تعليق